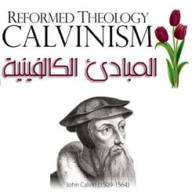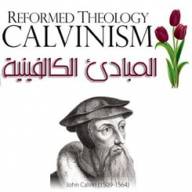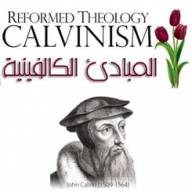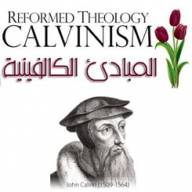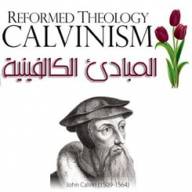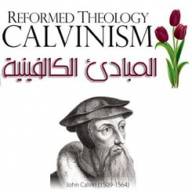تحتفل الكنيسة اللوثرية في الحادي والثلاثين مِن شهر أكتوبر مِن كلِّ عام بعيد الإصلاح. وفي مثل هذا العيد تقف الكنيسة وقفة إجلال لذاك المصلح الكبير مارتن لوثر الذي حمل مشعل الإنجيل عاليًا ماحيًا الظلام عن وجه الكنيسة المسيحية معلنًا عن إشراق فجر جديد في تاريخ الكنيسة.
تحتفل الكنيسة اللوثرية في الحادي والثلاثين مِن شهر أكتوبر مِن كلِّ عام بعيد الإصلاح. وفي مثل هذا العيد تقف الكنيسة وقفة إجلال لذاك المصلح الكبير مارتن لوثر الذي حمل مشعل الإنجيل عاليًا ماحيًا الظلام عن وجه الكنيسة المسيحية معلنًا عن إشراق فجر جديد في تاريخ الكنيسة.
ومرت الأيام بل لقد مضى قرابة خمسة قرون على ذلك اليوم الحاسم مِن تاريخ كنيستنا. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل انتهى عصر الإصلاح بموت المصلِّح؟ هل أصلحت حال الكنيسة فعلًا؟ هل قضي على الفساد الديني حقًا؟ أم أنَّ الكنيسة اليوم بحاجة ماسة إلى إصلاحٍ جديدٍ؟
وأنظر حولي فأرى الفساد وقد دبَّ في جسد الكنيسة مِن جديد، فتدهور حالها وساءت أحوالها. نخال كنيسة القرن العشرين قد رجعت إلى الوراء إلى تلك العصور الوسطى المظلمة لتغط في نومها مِن جديد.
إذًا فالكنيسة وأخص بالذكر الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هنا في المشرق العربي بحاجة اليوم إلى إصلاح جديد. كيف سنستطيع إصلاح هذه الكنيسة؟ وهل تجدي رسالة الإصلاح التي نادى بها مارتن لوثر نفعًا لكنيستنا الإنجيلية اللوثرية اليوم؟ هل مِن فائدة تجنيها كنيستنا العربية مِن قوة الإصلاح التي قام بها مارتن لوثر؟ هل نسطيع أن نضيء مصابيح كنائسنا مِن شعلة الإصلاح المتقدة لتنير لنا دربنا؟
نادى المصلح الكبير مارتن لوثر بأمورٍ ثلاث أراها ما زالت مهمة لنا نحن إنْ أردنا إصلاح كنيستنا الفتية.
1) كهنوت جميع المؤمنين:
إنَّ الفكرة الرئيسية في الإصلاح الإنجيلي هي كهنوت جميع المؤمنين. لم يكن للفرد العادي، لم يكن للعلماني أي قيمة تُذكَر في كنيسة القرون الوسطى. فلم يكن له حق الإتصال المباشر مع الله. لم يكن له الحق في قراءة الكتاب المقدَّس ولا تفسيره. بل لم يكن له الحق حتى في التمتع بغفران الله ونعمته.
أجل احتكر رجال الدين في القرون الوسطى الدين، فراحوا يصدّرون الفتاوى والصكوك يكبلون بها البسطاء مِن أفراد الشعب، بل ونصب العديد مِن الكهنة والفقهاء أنفسهم ممثلين عن الله على الأرض يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يخشون ويكفرون مَن دعا للتفكير والتغيير والتجديد.
كان العلماني ضعيفًا لدرجة أنَّه لم يكن بإستطاعته التقرب إلى الله إلا بواسطة رجال الدين والقديسين فحسب. نعم احتكر رجال الدين دين المسيح فجعلوه قصرًا عليهم وارتفعت قيمة الكاهن حتى أضحى ممثلًا لله على الأرض يحلل ما يشاء ويحرِّم ما يشاء.
فثار مارتن لوثر وأبى أنْ يقيّد نفر مِن المنتفعين بالدين حرية فكره وعقله وضميره، وأصر على حرية التفكير في زمن التفكير. فحرية الضمير هي مِن حرية المسيح...
وجاء لوثر ثائرًا معلنًا نهاية الإحتكار الديني في الكنيسة. جاء لوثر يبشِّر بكنيسة جديدة كل مؤمن فيها كاهن لله. جاء لوثر مناديًا إنًّه بإمكان كلِّ إنسان أنْ يقترب إلى الله في أي وقت شاء ودون الحاجة إلى واسطة بشرية إذ أنَّ المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس. افرحوا أيها الشعوب، فكل مؤمن فيكم كاهن لله بالمسيح يسوع. تهللوا أيّها الجموع فلا فضل للكاهن على علماني بعد اليوم إلا بالإيمان.
لا مكان بعد اليوم للسيطرة الكهنوتية ولا للهيمنة الإكليركية. جميع المؤمنين كهنة: هذه الحقيقة التي وصل إليها لوثر عن طريق قراءته للكتاب المقدَّس مهمة جدًا لكنيستنا الفتية في هذه البلاد بالذات.
ليت الله يوقظ أفراد طائفتنا ليعوا حقوقهم. أنتم كهنة الله. لكم الحق كل الحق في قراءة الكتاب المقدَّس وتفسيره. لكم الحق في الاشتراك في إتخاذ القرارات التي تخص مستقبل كنيستنا. أنتم كهنة الله....
لكم الحق في المساهمة الفعّالة والجدية في بناء هذه الكنيسة.
أنتم كهنة الله....لكم حقوقكم فلا تفرطوا بها، ولكم واجباتكم فتقيدوا بها. أنتم كهنة الله...فأنتم مسئولون أمام الله عن نشر ملكوته بين البشر. أنتم كهنة الله... فبشروا بعضكم بعضًا بإنجيل المسيح عيشوا ككهنة
قديسين. لا تنظروا إلى الراعي وتطلبوا منه، لا تطلبوه مِن أنفسكم فكلكم سواسية أمام الله. كل ما أردتم أنْ يعمل القس بكم، أفعلوا هكذا أنتم أيضًا ببعضكم البعض.
إنَّ عقيدة كهنوت جميع المؤمنين أعطت للحياة معنًى جديدًا، إذ أعطت كلَّ عملٍ بشريٍ بُعدًا روحيًا، فالمعلم كاهن في مدرسته، ينتظر منه الله أنْ تكون خدمته قربانًا مرضيًا، والعامل عليه أنْ يبدع ليصير عمله قطعة فنية تنال رضى الله، والطبيب الذي يعالج مرضاه إنما يكهن لله ويخدمه، فالحياة برمتها أصبحت قداسًا مقدَّسًا، وصغائر الأمور أضحت قرابين مكرسة، والعمل اليومي أصبح صلاة تصعد إلى قلب الله.
هذه هي رسالة الإصلاح، ما زالت حية تتكلم لنا نحن أبناء القرن العشرين، نحن أبناء المشرق العربي. أما الأمر الثاني فهو:
2) إنَّ الإصلاح إنَّما هو حاجة يومية وثورة مستمرة.
عاشت كنيسة القرون الوسطى مؤمنة بأنها قد حوت بين أضلاعها الحق الكامل، واعتقدت بأنها قد وصلت إلى قمة مجدها وأنها أضحت كنيسة مقدَّسة لا غضن فيها ولا ضعف. ونسيت الكنيسة أنَّ مَن ظنَّ أنَّه قد وصل فهو بالحقيقة تائه، وأنَّ الذي يفكِّر أنَّ الكنيسة تستطيع أنْ تكمِّل مسيرتها ’’كما كان في البدء وهو الآن وسيبقى إلى الأبد‘‘ لم يدرك كنه وسر الكنيسة. فالكنيسة بحاجة إلى إصلاح مستمر، وتجديد لخلاياها بلا إنقطاع، فهي إنْ سُمرَت في مكانها ماتت وفقدت حيويتها، وإنْ هي بقيت على حالها أضاعت جوهرها.
وإنْ لم تنفض عنها غبار الأيام أمست مؤسسة ليس إلا. فالكنيسة بحاجة إلى إصلاح مستمر، كما أنَّ المسيحي يفتقر إلى إنتفاضة يومية، وهي ما أسماها لوثر بالتوبة.
قال لوثر في حجته الأولى أنَّ الله يريد أنْ تكون حياة المؤمن حياة توبة مستمرة، فما أسهل أنْ يعتاد الإنسان على عمله وعلى خدمته وعلى نمط تفكيره، وما أسرع أنْ يتحجر الإنسان في روتين عمله، فلا يعود يفكر في ما يعمل ولا يراجع نفسه ولا ضميره ويحيا حياته كسفينة تمخر عباب البحر ولكن بلا هدف تقصده أو ميناء تسير بإتجاهه.
حياة التوبة هي ما ينتظره الله منا، حياة، كل يوم فيها يجلب معه تحديًا جديدًا وكل ثانية فيه تحثنا على إعادة التفكير، وعلى فحص الضمير وعلى تقييم المسيرة. أما الأمر الثالث:
3) التمييز بين ملكوت الله وملكوت العالم….
هذا الفكر جاء ضد الكنيسة الكاثوليكية التي جمع البابا فيها السلطتيْن معًا، وبهذا كان المصلح ضد أية دولة دينية تجتمع فيها السلطتان معًا…. لأنَّ الخلط بين سلطة الدين والدنيا مخيف، لأنَّ السلطة المدنية
إنْ أعطت لنفسها تبريرًا دينيًا أصبحت دكتاتورية مخيفة، لأنَّ مَن يقف ضد الحاكم إنَّما يحارب الله، ومَن يحارب الله فهو مرتد، ومَن يرتد يسهل قمعه وقتله واستبعاده.
ولكن وفي الوقت ذاته رفض المصلِّح الفصل الكامل بين الملكوتيْن، مثلما فعلت بعض الكنائس الحرة على زمنه، والتي رفضت النظام المدني كونه لا يعمل حسب القوانين الدينية.
رفض المصلِّح الحليْن… وقال بأنَّه يجب التمييز لا الفصل والإنخلاط بينهما، وعلينا أنْ ندرك الوسائل المختلفة للملوكتيْن…. ملكوت الله له وسيلة واحدة وهي الإنجيل ومع الإنجيل المحبة، أما الملكوت الأرضي، الدولة، فلها وسائل أخرى كالناموس والقانون ولذلك هي بحاجة إلى القوة…. وأظن أنَّ هذا التمييز مهم لنشوء نظرية الدولة الحديثة…. وكأنَّنا بالشرق ما زلنا نعيش في القرون الوسطى نخلط ما بين الملكوتيْن…. أو بين العالم كما هو وبين العالم كما نحلم به…. العالم كما هو يسير على شريعة الغاب، والقوي يأكل الضعيف، والمصالح هي، تتحكم بقرارات الدول… أما العالم كما نحلم به فهو عالم العدالة والمحبة والسلام والرخاء إذا لم نميز بين الاثنيْن لا نستطيع أنْ نأخذ القرارات الشجاعة والصحيحة، بل نبقى في تخبط وإرتباك وقلق…. أولئك الذين ينتظرون مِن القمم العربية، أنْ تأخذ القرارات التي يحلمون هم بها هم في الواقع لا يميزوا بين العالم كما هو وبين العالم كما هم يحلمون به.
فقط إذا فهمنا هذه المعادلة نستطيع أنْ نؤثر في صنع القرار أيها الأحباء، وإلا سنبقى إما فقط نستجدي، أو نحلم ونحمل، أما إنْ ميزنا بين العالم كما هو وكما نريده، عندها نستطيع أنْ نكون قوة فاعلة ومؤثرة ومغيرة.
وهذا هو هدف الإصلاح الأول والأخير. ألّا نبقى … متفرجين، بل فاعلين ومؤثرين ومصلحين.