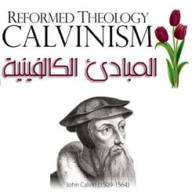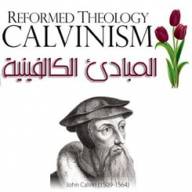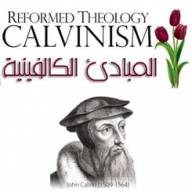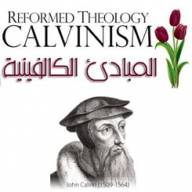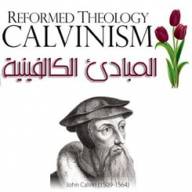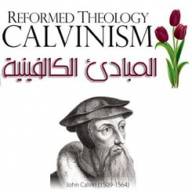يعتبر مارتن لوثر (1483-1546) - مؤسس المذهب البروتستانتي - أحد كبار المصلحين في تاريخ الإنسانية وأكثرهم إثارة للجدل. فمن كان يتصور أن يقف هذا الراهب الكاثوليكي الألماني البسيط ابن الفلاحين الفقراء معارضًا بابا روما بكل هيلمانه وصولجانه وسلطانه؟ ومن كان يرِد بخاطره أن يثور هذا الإنسان الخجول الهادئ شديد التدين الحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت والذي يعمل أستاذًا لدراسات الكتاب المقدس - هذه الثورة العارمة في وجه الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي في الأساس إلى سلك رهبانيتها، وأن يتهمها علانية وبشجاعة منقطعة النظير بالنصب؟ إنه لم يكتفِ بالمعارضة الشفهية، وإنما سطر اعتراضاته في خمسة وتسعين بندًا قام بعرضها على باب كنيسة فتنبرج في 31 أكتوبر عام 1517 في فضيحة مدوية هزت العرش البابوي المقدس، ولم يفق البابا من صدمته إلا وقد وجد المئات بل والآلاف من أتباع كنيسته من الفلاحين والفقراء والبسطاء وقد تحولوا أيضًا إلى معترضين يتبعون هذا الراهب المصلح، وهنا عُرفوا بتسميتهم التاريخية التي تلازمهم حتى اليوم: البروتستانت أو المعترضون.
يعتبر مارتن لوثر (1483-1546) - مؤسس المذهب البروتستانتي - أحد كبار المصلحين في تاريخ الإنسانية وأكثرهم إثارة للجدل. فمن كان يتصور أن يقف هذا الراهب الكاثوليكي الألماني البسيط ابن الفلاحين الفقراء معارضًا بابا روما بكل هيلمانه وصولجانه وسلطانه؟ ومن كان يرِد بخاطره أن يثور هذا الإنسان الخجول الهادئ شديد التدين الحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت والذي يعمل أستاذًا لدراسات الكتاب المقدس - هذه الثورة العارمة في وجه الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي في الأساس إلى سلك رهبانيتها، وأن يتهمها علانية وبشجاعة منقطعة النظير بالنصب؟ إنه لم يكتفِ بالمعارضة الشفهية، وإنما سطر اعتراضاته في خمسة وتسعين بندًا قام بعرضها على باب كنيسة فتنبرج في 31 أكتوبر عام 1517 في فضيحة مدوية هزت العرش البابوي المقدس، ولم يفق البابا من صدمته إلا وقد وجد المئات بل والآلاف من أتباع كنيسته من الفلاحين والفقراء والبسطاء وقد تحولوا أيضًا إلى معترضين يتبعون هذا الراهب المصلح، وهنا عُرفوا بتسميتهم التاريخية التي تلازمهم حتى اليوم: البروتستانت أو المعترضون.
لقد كان مما أحزن مارتن لوثر حزنًا كبيرًا وأثر في نفسه أيما تأثير الزيارة التي قام بها لروما عام 1511 تبركًا بالمقر الرسولي، لقد كان يظنها قلب الكاثوليكية النابض وانتظر أن يرى فيها قمة النقاء والتدين والرهبانية، فما وجد فيها إلا فسادًا وإفسادًا وفسوقًا وبهتانًا، ويبدو أن هذه الزيارة هي التي غيرت مجرى تفكيره بالكامل ومهدت لانفجاره بعدها بحوالي ست سنوات في وجه الجميع. لقد صبر مارتن لوثر كثيرًا على العديد من التجاوزات التي كانت تدور تحت سمعه وبصره في رحاب كنيسته الكاثوليكية، ولم تنفد سهام صبره إلا بعد أن جاءته القشة التي قصمت ظهر البعير، هذه القشة كانت: صكوك الغفران. فقد عانت الكنيسة الكاثوليكية من أزمة مالية من جراء بناء كنيسة القديس بطرس في روما، ووجد البابا ليو العاشر حلا سحريا لهذه الأزمة، وتمثل هذا الحل في بيع الغفران للمؤمنين، وقام بمساعدة البابا على نشر وتنفيذ هذه الفكرة راهب دومينيكي يُدعى يوهان تتسل، وقد شجع هذا الأخير المؤمنين على شراء الغفران لأحبائهم المتوفين الذين يُعذَّبون في "المطهر" جزاء ما اقترفوه من ذنوب! وكنتيجة طبيعية لهذه الدعوة التي بدأها صاحب القداسة رأس الكنيسة الجامعة (إذ أن كاثوليكي تعني جامعي أو مسكوني)، تدفقت الأموال من جيوب المؤمنين الساذجين.
في الواقع، لم يكن مارتن لوثر في حاجة إلى أكثر من ذلك لينفجر غاضبا في وجه هذا الاستغلال اللا إنساني لحاجة الناس وهذا الكذب المقنن لخداعهم، فهبت عاصفته العاتية من قلب هدوئه الظاهري لتعلن عن ميلاد مذهب جديد في الديانة المسيحية، فيما عُرف تاريخيًّا بحركة الإصلاح الكنسي.
وقد قامت دعوة مارتن لوثر أولا على ألا تكون هناك أية واسطة بين الإنسان وربه، إذ يجب أن يلجأ الإنسان دومًا إلى الله بدون وسيط وهو وحده الذي يغفر الذنوب وليس الكاهن في الكنيسة. وثانيا اعتمدت آراؤه على نصوص الكتاب المقدس وحدها دون غيرها من النصوص أو الآراء الكنسية، وبناء عليه رفض شفاعة القديسين والتبرك بآثارهم أو برفاتهم، كما رفض بشكل عام فكرة القداس الإلهي ووساطة الكاهن للشفاعة والغفران بين المؤمنين والإله الواحد، ودعا إلى عدم فرض الرهبنة على رجال الدين، وقد تزوج هو شخصيا من الراهبة كاترين فون بورا وأنجب منها ستة أطفال.
وأمام الثورة الهائلة التي تسبب فيها مارتن لوثر في وجه الكنيسة الكاثوليكية التي لم يكن يجرؤ أحد على مجرد التفوه بمعارضتها ولو بكلمة، أصدر البابا ليو العاشر في عام 1520 مرسومًا يقضي بحَرْم مارتن لوثر وطرده من رحاب الكنيسة الكاثوليكية، فقام مارتن لوثر في شجاعة قتالية بحرق المرسوم البابوي المقدس في الساحة العامة علنًا وعلى رؤوس الأشهاد! وهنا، كانت هناك خطورة كبيرة على حياته، فقرار الطرد الكنسي معناه أن صاحبه مهرطق وهي تهمة لا تُنسب إلا إلى من يُحكم عليهم بالإعدام حرقًا، أي أنها تهمة الموت. ولكن، لم يكن عالم مارتن لوثر يخلو من الأصدقاء والأحباء، فقد قام أتباع صديقه فردريك حاكم ساكسوني - وبإيعاز من هذا الأخير - باختطافه ونقله إلى قلعة ووتمبرج الحصينة، فقد كان الصديق يخشى على حياة صديقه دون أن يتمكن علنًا من توفير الحماية له، فقرر اختطافه وتسكينه في مكان آمن. وخلال مدة الشهور العشرة التي قضاها في القلعة، قام مارتن لوثر بترجمة الكتاب المقدس من اليونانية إلى الألمانية، فاعتبر هذا العمل الضخم حجر الأساس في تاريخ الأدب الألماني، وبهذه الطريقة، جعل مارتن لوثر الكتاب المقدس في متناول الفقراء والبسطاء والفلاحين يقرأونه ويفسرونه بعد أن كانت ترجمته ممنوعة وقراءته وتفسيراته حكرًا على آباء الكنيسة الكاثوليكية وحدهم دون غيرهم.
ومع مرور السنوات، أصبح أمل الكنيسة الكاثوليكية في القضاء على مارتن لوثر سرابًا وأوهامًا، ذلك بأن الزيادة المطردة والمتضاعفة في أعداد التابعين لكنيسته الجديدة جعلت من المستحيل تنفيذ حكم الإعدام فيه دون أن تقوم ثورةٌ عارمة قد تزيد من حرج الكنيسة الكاثوليكية التي كشفها المصلح الشجاع أمام الجميع، فقضى مارتن لوثر ما تبقى من حياته في زيارة الكنائس التي اتبعت مذهبه الجديد، ومات على إثر إصابته بنـزلة برد في 18 فبراير 1546، ودُفن في الكنيسة نفسها التي قام بنشر اعتراضاته الخمس والتسعين على بابها.
وقد كان مارتن لوثر وسيظل شخصية مثيرة للجدل الكبير والمتنوع، ذلك بأن آراءه الشُجاعة والجرأة الشديدة التي انتهجها في إعلانه لهذه الآراء قد اتخذت شكل الشطط أحيانا. ومن ذلك آراؤه الشهيرة في اليهود، ففي بداية دعوته، وجَّه نداءً إلى اليهود رغبةً منه في أن يعتنقوا المسيحية إذ رأى أن هذه هي النتيجة الطبيعية لأن المسيح قد وُلد يهوديا وقد بدأ رسالته بدعوتهم، ويبدو أن ضعف تجاوب اليهود مع دعوته قد أحبطه بشدة فانقلب عليهم بعد ذلك انقلابا عنيفًا. ومن المدهش أنه بعد قرون عديدة من الرأيين المتناقضين، تم استغلالهما لخدمة أهداف سياسية. فقد اعتمدت بعض القوى اليمينية المتطرفة خاصة في إنجلترا وأمريكا على آراء المرحلة الأولى لمارتن لوثر – فيما ليس للمصلح الكبير أي شأن به – في تأسيس ما يُعرف بالمسيحية الصهيونية التي تدعم فكرة ضرورة السيطرة الكاملة لليهود على فلسطين وإعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى حتى يتحقق وعد الرب وتحل البركة على العالم ويعود المسيح على الأرض ليحكم ألف عام. كما تبنى أدولف هتلر آراء المرحلة الأخيرة لمارتن لوثر، واتخذها ذريعةً لإقامة المذابح والمحارق لليهود داعيا إلى إبادتهم والتخلص الأبدي منهم.
وفي العصر الذي عاشه مارتن لوثر، كان المسلمون قد تم طردهم من إسبانيا بعد سقوط غرناطة آخر معاقلهم في الأندلس عام 1492، كما كانت الإمبراطورية العثمانية قد خرجت من عقالها وأصبحت قوة عسكرية كبيرة وبدأت في اجتياح مناطق في أوروبا، وتشير بعض المصادر إلى أن مارتن لوثر – وهو في الأساس الباحث اللاهوتي وحامل درجة الدكتوراه في هذا المجال – قد انتابه الفضول للتعرف على هذه القوة الجديدة التي تدين بدين غير المسيحية. وقد بحث وراء هؤلاء "المحمديين" كما كان يُطلق عليهم في أوروبا، وأعياه البحث عن المصادر العلمية التي تتحدث عن هذا الدين إما لكونها غير متوفرة أو لكون المتوفر منها يقدم صورة سيئة تفتقر إلى الموضوعية التي يستند إليها عقل أي باحث. وقد ظل يبحث إلى أن استطاع العثور على نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللاتينية فقرأها، وهنا، تتضارب المصادر في آرائه حول الإسلام بشكل عام، فمنها ما يذكر أنه أُعجب بخلو العقيدة الإسلامية من التعقيدات اللاهوتية، ومنها ما يذكر أنه كان مؤرقًا للغاية من السبب الذي جعل أتباع هذا الدين لا يؤمنون بألوهية المسيح ولا بصلبه ولا بقيامته، ويبدو أن الكثير من الأفكار قد اجتاحت عقله بشأن الإسلام لكن من الواضح أنه لم يجد في المصادر العلمية المتاحة في هذا العصر ما يُخمد نيران تساؤلاته.
وما يهمنا في هذه الجزئية هو روح الباحث التي ظلت ترافق مارتن لوثر طوال حياته، والتي دفعته إلى الاطلاع على دين آخر، مع الوضع في الاعتبار أن الكنيسة الكاثوليكية في أوج سلطانها كانت تحرم اقتناء – مجرد اقتناء – أي عمل مكتوب لا ترضى عنه. وبناءً على ذلك، يكون اطلاع – مجرد اطلاع – مارتن لوثر على تفاصيل دين آخر وإقدامه على قراءة كتاب مقدس آخر هو في حد ذاته ثورة معرفية ذات أبعاد متعددة تدل على عقلية منفتحة وروح تهفو إلى آفاق لا حدود لها من العلم والمعرفة.
هذا هو مارتن لوثر، خالد الذكر والمصلح الكبير، الذي زلزل الأرض تحت أقدام الكنيسة الكاثوليكية العتيدة، وتمسك بآرائه حتى اللحظة الأخيرة من حياته. وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع آرائه جملةً وتفصيلاً، وبغض النظر أيضًا عن تداعيات هذه الآراء وتفسيراتها، فإننا لسنا هنا بصدد محاكمته، ولا نهدف إلى تقييم آرائه الدينية أو الفكرية بالسلب أو بالإيجاب، نحن ننظر إليه كحالةٍ فريدة من المقاومة الفكرية والرغبة الحقيقية – وليست الدعائية – في الإصلاح. نحن نهدف إلى تقديم نموذج تاريخيّ فذ صنعته شجاعة رجلٍ واحد، وقف وحده لا يطلب المساعدة إلا من الله. رجلٌ واحدٌ وقف في مواجهة قوةٍ هائلة كانت تسحق كل من يفكر مجرد التفكير في معارضتها، قوةٍ عاتية معاديةٍ للعلم وللتفكير وللابتكار والإبداع، قوةٍ غاشمة تتبنى الفكر القمعي مدعومًا بالتعذيب الوحشي والحرق والصلب والتقطيع والسحل والترويع، قوةٍ فاسدة تتفنن في إحاطة فسادها بهالات التدين والقداسة. لم يطلب مارتن لوثر قط مساعدةً من أحد، لكن، بادرت آلاف الأيدي بمساعدته ومؤازرته والوقوف بجانبه، الآلاف ممن آمنوا بدعوى الحرية من أسر القمع والاستبداد الديني والفكري.
لقد عاشت أفكار مارتن لوثر حتى يومنا هذا، كما عاشت روحه المقاتلة الشجاعة، وليس من المبالغة القول بأنه أحد كبار المصلحين في التاريخ، لأنه وإن كانت له شطحاته الفكرية، إلا أنه مما يدعو للإعجاب بشخصه أنه تمسك برأيه باستماتة حتى آخر لحظة في حياته، ولم يستطع مخلوق زحزحته عنه قيد أُنملة، شأنه في ذلك شأن المصلحين الكبار عبر التاريخ الإنساني الذي يرحلون بأجسادهم، لكن تظل مواقفهم مصدر إلهام لكل الأجيال التي تأتي بعدهم.
وفي منطقتنا العربية أعدادٌ تستعصي على الحصر من المفكرين والمثقفين ومن يسمون أنفسهم أصحاب رسالات فكرية، لكن للأسف، تجذبهم التيارات المختلفة يمينًا ويسارًا، ويهتم الكثير منهم بتوطيد علاقاته مع السلطة لعل وعسى، كما يهتم الكثير منهم بتحقيق الأمان المادي أو الشهرة المدوية وليس بتحقيق الإصلاح الحقيقي، وليس عند الكثير منهم أدنى استعداد لتقديم أية تضحيات من أي نوع، فمعظمهم يحسبها بمقدار الاستفادة وليس بمقدار الإفادة. ووسط كل هذا الخضم من الأفكار أتساءل: هل من الممكن أن يتم الإصلاح في مجتمعاتنا على يد أحد من هؤلاء؟ أم أنه سيتم على أيدي آخرين من المثقفين الحقيقيين المطمورين بفعل فاعل ومع سبق الإصرار والترصد؟ وهل بين هؤلاء مارتن لوثر آخر يستطيع أن يقف في وجه التسلط والتخلف والتدين الزائف والقوى العاتية متنوعة الدرجات والاتجاهات محققًا لمجتمعه إصلاحًا بالمعنى الحرفيّ للكلمة؟ هل هو موجود الآن ينتظر صكوكًا للغفران تُخرجه ثائرًا من صمته؟ هل حقًّا بيننا مارتن لوثر؟