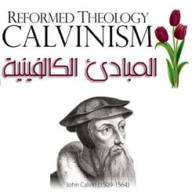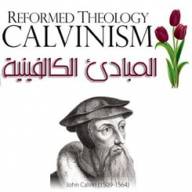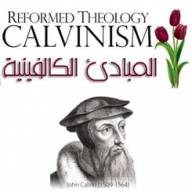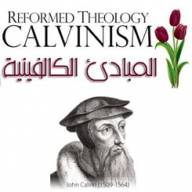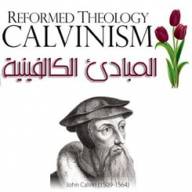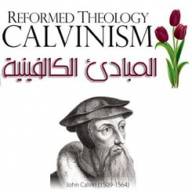ساد الفسادُ وانتشر الشرُ بين رجال الدين وعامَّة الشعب في كنيسة العصور الوسطى ويذكر المؤرخون عن هذه الحقبة أنَّ سلطة رجال الدين ازدادت، وثروتهم كثرت، وممتلكاتهم تضخَّمت، ولذلك تنافس الناس لكي يحصلوا على الوظائف الكهنوتية، وكانوا يشترون هذه الوظائف بالرشوة
ساد الفسادُ وانتشر الشرُ بين رجال الدين وعامَّة الشعب في كنيسة العصور الوسطى ويذكر المؤرخون عن هذه الحقبة أنَّ سلطة رجال الدين ازدادت، وثروتهم كثرت، وممتلكاتهم تضخَّمت، ولذلك تنافس الناس لكي يحصلوا على الوظائف الكهنوتية، وكانوا يشترون هذه الوظائف بالرشوة
والمال دون أن يكونوا أصحاب رسالةٍ روحية، ففسدت الأخلاق وعمَّت الرذيلة وكانت أشرُّ الموبقات تحدث في أعلى المستويات الكنسيَّة التي كانت تبيع صكوك الغفران بزعمٍ أنَّ من سلطاتها أن تفرض على الناس بعض العقوبات لأجل خطاياهم وما على الناس إلا أن يشتروا صكوك الغفران حتى ترفع عنهم الكنيسة العقوبات والتأديبات الكنسيَّة، وجلبت هذه الصكوك أموالاً طائلة للكنيسة وكانت أنواع الصكوك مختلفة النوع ومختلفة السعر، وكل خطية كان لها الصكُّ الذي يتناسب معها. نتيجةً لذلك كان من الطبيعي أن تُختزل المسيحية في بعض الطقوس الجوفاء، وفي قلب هذا الظلام المدلهم ظهر مارتن لوثر وكتب 95 قضية هاجمَ فيها بيع صكوك الغفران وعلَّقها على باب كنيسة وتنبرج يوم 31/ 10/ 1517. وبعد معاناةٍ وصراعٍ ومحاكماتٍ شتَّى أصدر البابا في يناير 1521 قراراً بحرمان مارتن لوثر وصرَّح بأنه يستحق كل عقوبات الهراطقة، ولكن كل هذا لم يعرقل مسيرة الإصلاح فعندما ذاعت تعاليم لوثر بعدم عصمة البابا وأنَّ التبرير يكون بالإيمان بالمسيح، وابتدأ مذهبه يكتسب أنصاراً في ألمانيا وسويسرا حاولت الكنيسة بشتَّى الطرق أن توقف تقدُّم هذا الفكر وأن تحدّ من حرية المصلِحين، لكن نبلاء الإنجيليين قالوا عبارتهم المشهورة «we protest» أي إننا نحتجّ على الظلم وعلى وضع القوانين الجائرة التي تعيق تقدُّم الفكر. ومنذ ذلك الوقت ظهرت كلمة البروتستانتية التي ترمز إلى الريادة في المناداة بحرية الفكر وحرية الاعتقاد، هذه الحرية التي فتحت أمام العالم باب الحضارة والتقدُّم في مختلف المجالات والتي أصبحت حقاً أساسياً تكفله دساتير العالم المتحضِّر، الحرية التي هي حق لكل إنسان سواء كان ضمن الأغلبية أو الأقلية، وقام الإصلاح البروتستانتي على عدَّة مبادئ سامية وهي: سموّ سلطان الكتاب المقدَّس وحق كل مؤمن في قراءته وتفسيره، وهذا عكس ما كان سائداً في العصور الوسطى حيث كانت الكنيسة لا تسمح لغير الكهنة بقراءة الكتاب المقدَّس وحرمت الكنيسة الناس من حق التفسير ومنحت هذا الحق للبابا، كما رفض الإصلاح البروتستانتي اعتبار التقليد الكنسي إتماماً للوحي المقدَّس ولكنه اعتبره مفسِّراً له، فالكتاب المقدَّس كامل وهو أساس العقيدة والسلوك، ويعود الفضل في ترجمة الكتاب المقدَّس للإنجيليين، لم تكن كنيسة العصور الوسطى تسمح لغير الكهنة بقراءة الكتاب المقدَّس وكان هؤلاء يقرأونه باللغة اللاتينية التي لم تكن لغة التخاطب بين الناس، فقام مارتن لوثر بترجمة الكتاب المقدَّس إلى اللغة الألمانية لغة الشعب وكان دائماً يقول إنني أريد أن أجعل الكتاب المقدَّس يتكلم كشخصٍ ألماني، لقد كان يريد أن يفهم الشعب الألماني فهماً كاملاً بلغته الكتاب المقدَّس؛ والمبدأ الثاني الذي قام عليه الإصلاح هو الخلاص بالإيمان وحده وليس بالفروض والمراسيم والأسرار التي فرضتها كنيسة العصور الوسطى على الناس باعتبارها لازمةً للمصالحة مع الله؛ والمبدأ الثالث هو كهنوت جميع المؤمنين، فليس هناك كهنوتٌ خاص وليس هناك من يتوسط في العبادة بين الله والناس، فجميع المؤمنين يمكنهم الاتصال بالله مباشرةً دون وسيط فالكاهن هو إنسانٌ مثل أي إنسانٍ يخطئ ويصيب، وعليه كأي إنسانٍ أن يتجه إلى الله ليعترف بخطاياه؛ والمبدأ الرابع هو حرية الضمير المسيحي، حيث إن كنيسة القرون الوسطى حرمت على الناس التفكير الحر، فخلال الأربعين سنة التي سبقت الإصلاح أحرقت الكنيسة نحو 1300 شخص بتهمة الهرطقة، لقد كان هناك حَجْرٌ على كل تفكير حر، ولكنَّ فجر الإصلاح أشرق على الفرد المسيحي بنور حرية الفكر والضمير. وكان من نتاج الإصلاح الديني المناداة بالزواج المدني، يقول رولاند بينتون أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة بيل الأمريكية في كتابه «الحب والجنس والزواج في التاريخ المسيحي» الذي نقله إلى العربية القس منيس عبد النور صفحة 52 ما نصُّه «على أنَّ لوثر لم يعتبر الزواج سراً كنسياً، وهو في هذا يبعد بين موقف البروتستانت والتقليديين من الزواج... فالبروتستانت يقولون إنَّ الزواج نظامٌ مدني، بينما يقول التقليديون إنه نظامٌ كنسي، فيقول لوثر إنَّ الفريضة الكنسيَّة يجب أن تكون مرسومة من المسيح ومخصَّصة للمسيحيين وحدهم، وهذا لا ينطبق على الزواج، فإن غير المسيحيين من يهود ومسلمين يتزوجون كما يتزوج المسيحيون وعلى هذا فإن الزواج نظامٌ طبيعي ولا حاجة لإجراءاتٍ دينية تجعله حلالاً».
وتكمن أهمية الإصلاح الديني في كونه يشكِّل أحد الأسباب البارزة للانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، ففي المرحلة السّابقة على الإصلاح كان الإنسان خاضعاً لسلطة الكنيسة خضوعاً تاماً فتمكَّن الإصلاح الديني من تحريره بصورة كبيرة وغير نهائية من السيطرة المزدوجة للكنيسة ورجال الحكم المدني، وحقَّق لـه كسباً في كثير من الميادين كان أبرزها الحرية والفردية بوصفهما مقدّمتين ضروريتين للديمقراطية التي حَمَلها وبشّر بها العصر الحديث، عصر الرأسمالية والتنوير في أوروبا لاحقاً. لقد أُطلقت حرية العبادة وأضحت تتّسم بطابع فردي يتمثّل في جعل العلاقة مباشرة بين الإنسان وربّه وأصبحت سلطة الضمير الفردية تحل محل سلطة الكنيسة والبابا، وأصبح الدين أمراً شخصياً، ودعا المصلِحون إلى قيام علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم وعلاقة الفرد بالدولة، وبعبارةٍ أخرى أحدثَ الإصلاح الديني نقلةً حقيقة في حياة الفرد والمجتمع من حالة الهيمنة الكنسيّة باسم الدّين إلى حالة انعتاق الفرد نسبياً من تلك الهيمنة باسم الإصلاح، وإعادة الاعتبار إلى الإنسان بوصفه كائناً إنسانياً وروحياً ينبغي أن يكون حرّاً من الناحية العَقَائدية والروحية، ولا يخضع لسلطة أحد غير الله، ولا لمراقبة أحدٍ غير الضمير. لقد حلّت سلطة الإنسان الفرد إلى جانب سلطة الكنيسة بوصفها سلطة دينية ودنيوية في تسيير شؤون حياته المختلفة، بعد أن كانت مختزلة في سلطة واحدة هي سلطة الكنيسة والبابا، الأمر الذي مهّد السبيل للانتقال إلى الحقبة الرأسمالية الحديثة. ونتيجةً للإصلاح جنحت المجتمعات الأوروبية الحديثة إلى فصل علاقة الدّين بنظام الحكم في الدّولة وبمجالات الحياة المختلفة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة والأخلاق، فأصبحت السلطة الوحيدة هي سلطة الإنسان العاقل، وليست سلطة الدين ومؤسّساته الروحية، فانتقل الإنسان من حالة الانعتاق الجزئي، إلى حالة الانعتاق الكلّي والشامل التي بات بموجبها مركزاً للكون، دون شريك أو منازع، الّتي لم يكن من الممكن الوصول إليها لولا الإنجاز الهائل والكبير الذي تحقق على يد دعاة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، ولذا يمكننا القول: إنَّ واحداً من أهم إنجازات الإصلاح الديني، هو الانتقال بالإنسان من سلطة كنسيّة دينية بابويَّة أحادية كان الإنسان عنصراً مفعولاً به فيها، إلى سلطة مزدوجة دينية ومدنية أصبح فيها الإنسان طرفاً فاعلاً، الأمر الذي جعل انتقال الإنسان من سلطة الشّراكة مع المؤسسة المسيحية إلى سلطة مدنية علمانية أمراً ممكناً في العصر الرأسمالي الحديث، لذلك فقد اتجهت البروتستانتية إلى الإشارة إلى الحكَّام الزمنيين ودعمهم، ومحاولة جعل وظيفة البابا مجرد وظيفة تهتم فقط بشؤون الدين، ومن هنا بدأت المحاولات لفصل الدين عن نظام الحكم أو السياسة، وهذه تُعد أول خطوات التوجُّه نحو الديمقراطية، خاصةً مع إبرازها لأهمية رأي الشعب وأن الكنيسة تُمثِّل كل المؤمنين ولا ضرورة لواسطة البابا، ولقد كان لأفكار لوثر الأثر الكبير، حيث أعطى للمواطن حق الاجتهاد الديني، ولم يعد هذا الاجتهاد حكراً على رجال الدين، حيث إنّ لوثر أعطى قيمةً كبيرة للعقل الإنساني الذي كان مقيَّداً من قِبل رجال الدين؛ لذلك يطلق المؤرِّخون على هذه الحقبة اسم عصر النهضة أو عصر التنوير أو عصر الإحياء، ففي ذلك العصر غزا العقل البشري مختلف الميادين وأصبح لا سلطان على العقل إلا العقل نفسه. إن المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها حركة الإصلاح الديني البروتستانتي هي التي دعمت تطوُّر الديمقراطية، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، أو بالمعنى الأصح أنعشَ الإصلاح الديني مفهوم الديمقراطية التي كانت في أثينا وأضاف عليه بعض التعديلات، ومن يقرأ التاريخ الإنساني بدقة سيكتشف أن معظم الشخصيات المؤثرة في التاريخ الإنساني جاءوا من خلفية بروتستانتية. لقد ذكر ميشيل هارت في كتابه الخالدون المائة الذين لهم أعظم التأثير في التاريخ: إنَّ العدد الأكبر من هؤلاء الخالدين جاء من بلاد تنتمي للبروتستانتية في شمال أوروبا وأمريكا، وعزا ذلك إلى الإصلاح البروتستانتي الذي كان له أعظم الأثر في نشر حرية التفكير الديني، وتجربة أوروبا وما مرَّت به من أحداث تختلف بالطبع عمَّا مرَّ به باقي العالم، ولذلك لا نستطيع أن نعمم هذه التجربة الديمقراطية على باقي الدول، لكن من المحتَّم ولتجنُّب الحروب الأهلية والدينية، لابد من أن يتم فصل الدين عن أنظمة الحكم وذلك لضمان حقوق جميع أفراد المجتمع ولتجنُّب طغيان الأغلبية على الأقلية، ليبقى الدين غذاء الروح حيث إنَّ الإنسان إذا كان مقتنعاً بدينه فإنه لن يرتكب المعاصي والمنكرات وأي شيء مخالف لتعاليم الدين، أما الدين المتصل بالحُكم فهو دين يركز على السياسة والسيطرة، مما قد يفقده قدسيَّته ويجعل هدفه الأساسي هو احتكار السلطة. والأسئلة التي أراها تفرض نفسها الآن: هل تنكَّر الإنجيليون – بغية مغازلة الأكثرية المسيحية - لمبادئ عصر الإصلاح؟ وهل أصبحت الكنيسة المصرية في حاجة إلى اجتهاد جديد في تعاملها مع النصوص الدينية؟ وهل أصبحت المنطقة العربية في احتياج إلى إصلاح ديني يناسب طبيعتها مثل ذلك الإصلاح الديني الذى ارتقى بأوروبا وجعلها تصل إلى ما هي فيه الآن من نهضةٍ وتقدُّمٍ ورُقيّ؟
الإجابة بوضوح على هذه الأسئلة هي التي ستحدِّد إلى أيِّ مستقبلٍ نحن نسير.
الإصلاح والوحدة الكنسية
ألا يوجد طريق لتحقيق وحدة الكنيسة إلا بالتنازل عن مبادئ الإصلاح الإنجيلي؟ ما معنى أن يقول أحد رعاة إحدى كبريات الكنائس الإنجيلية بالقاهرة أنه يصلي حتى تظهر العذراء في كنيسته؟ أيكون التقارب للكنائس الأخرى بالردة الفكرية وبالنكوص لما قبل الإصلاح؟ إننا ندعو للوحدة الكنسية ونساندها في ذات الوقت الذي لن نتنازل فيه عن ركائز الإصلاح التي قامت عليها البروتستانتية, ومن هنا فإن الكنيسة الإنجيلية تحتاج لإصلاح داخلي, والبداية لن تكون إلا بالعودة لمبادئ عصر الإصلاح التي تنكر لها البعض إما مغازلة للأغلبية, أو سعياً لتحقيق الشهرة, أو تنفيذاً لأجندة التمويل.