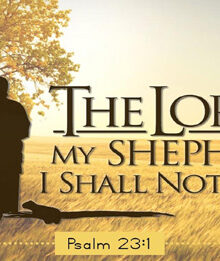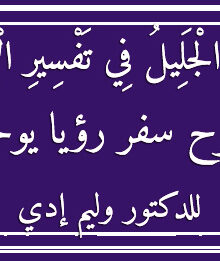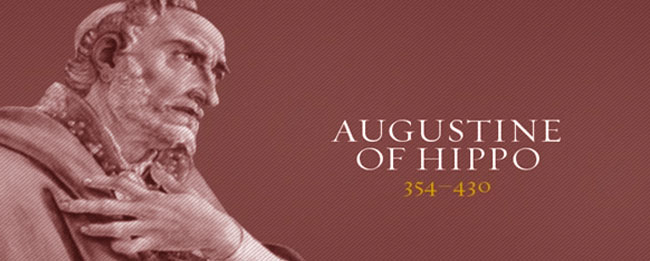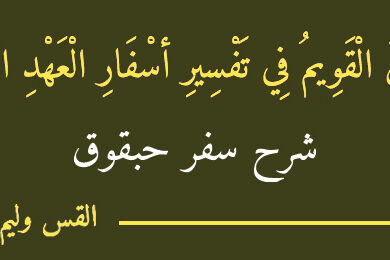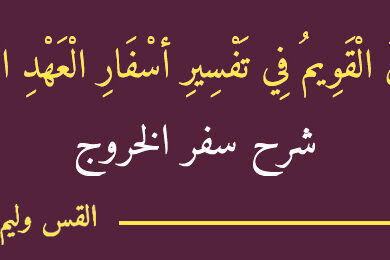-
عقيدتنا

-
 مايو 2, 2021
مايو 2, 2021العشاء الرباني .. عقيدة جون كالفن
-
 مايو 2, 2021
مايو 2, 2021مواهب الروح القدس
-
 مايو 15, 2021
مايو 15, 2021القيامة من منظور لاهوتي
-
 مايو 1, 2021
مايو 1, 2021العشاء الرباني في فكر كالفن
-
إقرارات الإيمان الإنجيلية

-
 أبريل 9, 2021
أبريل 9, 2021إقرار إيمان الكنيسة الإنجيلية المشيخية المتحدة
-
 أبريل 9, 2021
أبريل 9, 2021قانون الإيمان الرسولي
-
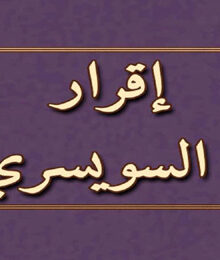 أبريل 9, 2021
أبريل 9, 2021إقرارالإيمان السويسري الثاني 1566م
-
 أبريل 9, 2021
أبريل 9, 2021إقرار إيمان بارمن
-
إصلاح إنجيلي

-
 مايو 3, 2021
مايو 3, 2021جون كالفن في الكتابات العربية المسيحية المعاصرة
-
 مايو 3, 2021
مايو 3, 2021المصلحون والفنون
-
 مايو 17, 2021
مايو 17, 2021الإصلاح الإنجيلي والكتاب المقدس
-
 يونيو 11, 2024
يونيو 11, 2024الكفارة المحدودة
-
شخصيات كتابية

-
 أبريل 29, 2021
أبريل 29, 2021برنابا القبرسي
-
 يوليو 13, 2011
يوليو 13, 2011نحميا
-
 مايو 8, 2021
مايو 8, 2021تيموثاوس
-
 يونيو 13, 2024
يونيو 13, 2024يوسف